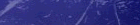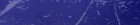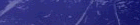مقدمات ظهور علم النفس واستقلاله
لماذا علم النفس؟
قد يكون الاعتراض على الحديث عن أهمية علم النفس وسماته في هذا المقام صحيحاً فيما لو كانت المسألة التي نعالجها تتعلق بأحد موضوعات هذا العلم أو بفرع من فروعه، خاصة وأن معظم كتب علم النفس المنشورة بلغتنا تتناول هذه القضايا في فصولها الأولى بصرف النظر عن مهمتها وعناوينها. وهذا ما خبره القراء في بلادنا، ولم يجدوا، في كثير من الحالات، مسوغاً منطقياً له. غير أن الأمر يختلف إلى حد كبير حين تكمن مهمة العمل في تتبع مراحل تطور علم النفس، وعرض أهم مدارسه و أشهر تياراته والتعريف بزعماء تلك المدارس والتيارات وأنصارها، وتحديد الموقع الفكري لكل منهم. ففي حالةٍ كهذه يبدو ضرورياً أن يقوم المؤلف، في البداية، بإبراز الخصائص العامة لهذا العلم، التي ينبغي مراعاتها والنظر إليه على أساسها.
إنَّ الفهم الخاطئ لخصائص علم النفس يعدّ واحداً من الأسباب التي تدعو إلى العودة إليها من أجل توضيحها، وتحفز على تحديد غايات هذا العلم ووسائله. فقد شهد هذا العلم، وما يزال يشهد، تبايناً في وجهات نظر العاملين فيه، مثلما عانى، ويعاني حتى الآن، من آراء بعض المفكرين والمثقفين القاصرة حيناً، والسلبية أحياناً. وهذا ما يميز "مناخ" علم النفس عن "مناخات" العلوم الأخرى: الطبيعية منها والاجتماعية، ولو بدرجات متفاوتة.
صحيح أن التباين في الآراء الذي يصل في بعض الأحايين إلى حدّ التناقض في مضمار علم النفس كان سبباً للمواقف السلبية والقاصرة خارجه، وأن ما كان قائماً وما هو موجود الآن على "خطوط التماس" أو بعيداً عنها قليلاً إن هو إلا صدى أو، على الأصح، ردّ فعل على ما يجري في داخله، ولكنه صحيح أيضاً أن يكون التأثير عكسياً. ذلك أن موقف الآخرين من علم النفس وخلافاتهم تؤثر، على نحو ما، على ممثلي هذا العلم عبر العديد من القنوات، وفي مختلف الأطوار والمراحل التي يمرون بها قبل نشاطهم العلمي وأثناءه.
ولعل تأثير الوسط الثقافي للباحث السيكولوجي لا يقتصر على مرحلة عطائه العلمي، ولا ينحصر ضمن حدود معرفية معينة، وإنما يتعدى ذلك ليشمل جميع سني حياته وكافة عناصر وعيه وأشكاله. وربما وضع البعض مسألة تأثير الثقافة الاجتماعية على العالم السيكولوجي في مرحلة نضجه الذهني والفكري على هامش الصفحة، ريبةً في صحتها أو، في أحسن الأحوال، محاولةً لإعمال الفكر فيها وتحليلها والتأكد من صدقها. وهذا ما لا نستغربه حينما نعرف أنَّ ما يمليه إجراء كهذا هو النظر إلى الموضوع المطروح بنظرة أحادية الجانب، أي من زاوية الأثر الذي يحدثه فكر العالم السيكولوجي ونظرته إلى مادة نشاطه وموضوعه في وسطه الاجتماعي، دون الاهتمام إلى الحدّ الكافي بالجانب الآخر المتمثل في دور ذلك الوسط بمختلف حلقاته ودوائره، وخاصة القريبة والضيقة منها، في هذا الفكر. فمن خلال هذا الدور تتحدد آراء الباحث وتتشكل مواقفه.
إنّ مرحلة النضج والعطاء عند الإنسان عامة، والباحث خاصة، ما هي إلا نتاج التفاعل والتواصل الاجتماعيين وثمرة من ثمار التربية بأوسع معاني هذه الكلمة عبر المراحل العمرية السابقة. ومهما حاول بعض العلماء تجاهل أو تجاوز كنه هذه العلاقة واتجاهها، فإن المعاينة الدقيقة تكشف عن وجود بصمات الوعي الاجتماعي على مجمل نشاطهم كمظهر من مظاهر الوعي الإنسانيّ. وهذا ما عبر عنه الفيلسوف البريطاني برترند راسل حين قال: "إن كل الحيوانات سلكت سلوكاً يتفق مع الفلسفة التي يعتنقها الشخص الملاحظ قبل أن يبدأ ملاحظاته. بل وأكثر من ذلك، فإنّ هذه الحيوانات قد أوضحت الخصائص القومية لصاحب الملاحظة. فالحيوانات التي قام الأمريكيون بإجراء الدراسات عليها تندفع في حالة من الهياج وبنشاط واستثارة واضحة غير عادية، وفي النهاية تصل إلى النتيجة المنشودة عن طريق الصدفة. أما الحيوانات التي قام الألمان بملاحظتها فتقف ساكنة وتفكّر، وفي النهاية تصل إلى الحلّ الذي يكون بعيداً عن شعورها الداخلي"،(منصور طلعت وآخرون، 1978، 101).
وما يهمنا من قول راسل، ونحن بصدد الحديث عن علم النفس وتاريخه، هو ضرورة العودة إلى الفلسفات التي كانت المنطلقات النظرية لعلماء النفس على اختلاف نزعاتهم، للوقوف على دورها الكبير في نشاطهم العلمي والنتائج التي توصلوا إليها. ومن غير هذا الإجراء، وما لم توضع النظرية في سياقها التاريخي –الفكري تظل في الكثير من جوانبها ومفاهيمها مجردة بصورة ما، ويتحول التأريخ لها إلى مجرد وصف أقرب للتصوير منه إلى العلم.
ومن المفيد أن نسوق مثالاً لا يقل أهمية من حيث قيمته التعبيرية وقدرته على إبراز العلاقة المذكورة عمّا قاله راسل. فقد كرس أصحاب "الأنتروبولوجيا السيكولوجية" أو "علم النفس الأنتروبولوجي" نشاطهم لخدمة النظرية العرقية النازية. فوجد الألماني آرنولد في كتابه "البنى السيكوفيزيائية عند الدجاج" أن سلوك الدجاج الذي ينتمي إلى المناطق الجنوبية من الكرة الأرضية يغلب عليه الخضوع السريع للدجاج الشمالي الذي يظهر على سلوكه الميل إلى التفوق وحب السيطرة والرغبة في إخضاع الأنواع الأخرى من الدجاج لسلطته. ويقول زميله ومواطنه ينيش بوجود خصائص عرقية موروثة عند الكائنات الحية تجعل من تفوّق بعضها على البعض الآخر أمراً حتمياً وطبيعياً.(منصور ف، 114-116).
إنّ هذه الأحكام لا تحتاج إلى تعليق. فهي، أياً كانت الزاوية التي يُنظر إليها من خلالها، تبرز بجلاء آثار المنطلقات النظرية للباحث السيكولوجي على تفسيره لمظاهر السلوك المختلفة.
كما تؤكد على ضرورة وضع الواقعة العلمية السيكولوجية، مهما كان حجمها وامتدادها، في مسارها الصحيح، ودراستها وفقاً لذلك.
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول إن من غير الممكن معرفة جوهر الظاهرة من غير تتبع مراحل تطورها، والوقوف على كمية ونوعية الصلات التي تربطها بغيرها من الظواهر القريبة منها والبعيدة عنها، والوصول، أخيراً، إلى القانون الذي ينظم حركتها. وهذا ينطبق على ظواهر الطبيعة، مثلما ينطبق على الظواهر الاجتماعية والإنسانية. ومن خلال هذا الفهم يكون التشديد على أهمية دراسة تاريخ علم النفس. فعندما يتم تناول مراحل تطور هذا العلم، وإبراز سمات كلّ مرحلة منها، وربط هذه السمات بعضها ببعض من جهة، وربطها بالشروط الثقافية لنشأتها وتبلورها من جهة ثانية، يصبح واقع هذا العلم وأهميته واتجاهه من الأمور الواضحة إلى حدّ يمكّن الدارس من معرفة ما لهذا العلم وما عليه، والتنبؤ بما يمكن وما ينبغي أن يكون حاله في المستقبل.
لقد نشأت وتطورت مدارس سيكولوجية عديدة. وتأتي مدرسة التحليل النفسي في طليعة هذه المدارس من حيث انتشارها وذيوعها. إذ تعدى أثر هذه المدرسة في فترة ما بين الحربين العالميتين خصوصاً ميدان علم النفس إلى ميادين أخرى كالأدب والتربية والفن.
إن لظهور هذه المدرسة أو تلك أسبابه الموضوعية المتعلقة أساساً بثقافة المجتمع(أو المجتمعات) التي عرفته. وهذا يعني ببساطة أن أياً من هذه المدارس هي الابنة الشرعية للمجتمع الذي ولدت فيه. وتبعاً لتوجهاته وتوجيهاته(المباشرة وغير المباشرة) ومستوى قبوله بها وتقبله لها تنمو وتتطور. وانطلاقاً من ذلك يمكن تفسير ظهور السلوكية وتعديل تعاليم مؤسسها ونشوء السلوكية الجديدة، وكذلك ضعف صدى حركة التحليل النفسي بعد الحرب العالمية الثانية... الخ.
وما قيل يؤلف –بالنسبة لنا- المبدأ العام الذي سوف نعتمد عليه في عرضنا التاريخي لعلم النفس في القرن العشرين. ويتجسد هذا المبدأ، مرةً أخرى وباختصارٍ، في وحدة الفكر الإنساني بما يحمله من تناقضات أولاً، ووحدة شخصية الإنسان ووعيه ثانياً، وأثر هذا الفكر في الشخصية والوعي ثالثاً.
لقد تحدثنا، حتى الآن، عن جانب واحد من المسألة المطروحة. أما الجانب الثاني فيحتوي على الصورة التي يحملها جمهور المثقفين والمتعلمين من غير المشتغلين في حقل علم النفس عن هذا العلم. ونبادر للقول بأن هذه الصورة ما زالت تتسم حتى الآن بالكثير من المغالطات والتشويهات، على الرغم ممّا كتب ونشر حول علم النفس.
إننا لا نجد كبير عناء في البرهان على وجود مثل هذه الصورة لدى الأغلبية الساحقة من الناس. فالحياة اليومية تزخر بالأمثلة والشواهد. وهي تقدمها لنا في كل حديث، وعبر أي حوار أو مقابلة نجريها مع الآخرين. ولكي لا يظل كلامنا نظرياً وتعسفياً فإننا نستعين بالنتائج التي انتهى إليها الدكتور مصطفى سويف.
قام الدكتور سويف بدراسةٍ مسحية على عينة تمثل مختلف قطاعات المجتمع المصري، وذلك من أجل معرفة نظرة الناس إلى علم النفس، من حيث موضوعه وأهميته على الصعيد العملي.
وقد كشفت الدراسة عن وجود أكثر من 1/5 أفراد العينة البالغ عددهم 500 شخصاً، يحمل تصوراً يضع علم النفس في صف واحد مع السّحر والشعوذة، وأن 3/5 المستجوبين قصروا موضوع علم النفس على جانب واحد فقط، هو الجانب الانفعالي. واعترف خمسهم بعدم وجود أي تصور لديه عن الموضوع. ولم يستطع تقديم إجابة قريبة من الواقع، حول مجال اهتمام علم النفس سوى عشرة أشخاص فقط.
وبيّنت الدراسة أيضاً أن 47% من العينة لا يعرفون أي عالم أو باحث يشتغل في حقل علم النفس، وأن 40% أوردوا اسم فرويد(ومعظمهم لم يذكر إلا اسمه). بينما صرح 53% من المجموعة بأنهم لا يعرفون شيئاً عن علم النفس، ولم يقرؤوا أو يطلعوا على أي شيء يتعلق به. واقتصرت مطالعة 18% من العيّنة على كتب ليست ذات صلة بتراث علم النفس، ككتاب "كيف تكسب الأصدقاء؟..."، ومطالعة 10% على بعض ما كتبه فرويد أو بعض ما كُتب عنه.(سويف، 1978، 3-20).
وتدلّل هذه المعطيات على أن علم النفس لم يتبوأ بَعْدُ مكانته الصحيحة لدى فئة المتعلمين والمثقفين في مجتمعنا، وأن معالمه وموضوعات اهتمامه غير معروفة إلى حدّ بعيدٍ من قبلهم.
وما دمنا نتكلم عن التصور العام حول علم النفس فمن الضروري أن لا ننسى ما يعكسه هذا التصور من فهم لدور الاختصاصي النفسي ومهماته. إننا لو رجعنا إلى العيّنة التي وزع على أفرادها الاستبيان وطرحنا عليهم سؤالاً عن طبيعة عمل الاختصاصي النفسي، لألفينا أن نسبة من الإجابات التي يمكن أن يدلي بها هؤلاء تعبر عن فهم ضيق أو مشوه لهذا العمل. فقد يتصور الكثير منهم أن المشتغل في علم النفس أشبه ما يكون بالساحر أو المنجم أو المشعوذ، وأن علم النفس يمدّ الإنسان بقدرة عجيبة على معرفة ما يجري في أذهان الآخرين وما يفكرون به، أو ما يرغبون بالتحدث عنه، أو معرفة أسرارهم لمجرد إجراء حوار قصير معهم. وفي أحسن الأحوال قد يرى بعضهم أن مهمة الاختصاصي النفسي تتمثل في تشخيص الأمراض النفسية وعلاجها. إن لكل واحدة من الحالتين المذكورتين بعداً ثقافياً تتأثر به وتقوم عليه في تقديم مثل هذه الإجابات. فالحالة الأولى تعكس –كما هو بيّن- فهم ممثليها لوظيفة علم النفس من زاوية أحد فروعه فقط، وهو الطب النفسي، دون غيره من الفروع الأخرى، أو من وجهة نظر التحليل النفسي دون غيره من الاتجاهات السيكولوجية. في حين ينطلق هؤلاء في الحالة الثانية من نظرتهم إلى الاختصاصي النفسي إلى أنه يتعامل مع موضوعات غير محسوسة. وهي بالتالي –حسب اعتقادهم- ذات طبيعة غريبة لا يُعرف مصدرها ولا تدرك نشأتها. وواضحٌ ما تحمله هذه النظرة في طياتها من رواسب الفكر القديم.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى وجود عوامل موضوعية وأخرى ذاتية تدفع بحالات كهذه إلى الوجود. فمن غير الإنصاف أن نُحمّل المتعلم وحتى المثقف مسؤولية ذلك كله، ونعفي الدوائر الثقافية والإعلامية والتربوية في المجتمع منها، إذا لم يكن هدفنا تجريد هذه الدوائر من صلاحياتها وإلغاء دورها أو تقزيمه بحكم قبلي.
إن ما ذكرناه حتى الآن يعتبر أحد الأسباب التي جعلت من هذا الفصل أمراً لازماً. ومن خلاله نعتقد بأننا أجبنا على الاعتراض الذي استهلينا به الحديث. ونوجز ما قلناه في هذا الشأن بعبارات أوضح. إن مهمة هذا الفصل تتجسد في تناول دور علم النفس وأهميته، ومع التأكيد على الروابط القائمة بين هذه المسألة ومسألة تكون الظواهر النفسية وتطورها والقوانين التي يخضع لها إبان ذلك، فإننا نعتبر أن دراسة الأولى منهما هي مهمة تاريخ علم النفس، بينما تشكل الثانية المهمة المركزية التي يجب على علم النفس العام أن يضطلع بها.
يتبع.......ز
لماذا علم النفس؟
قد يكون الاعتراض على الحديث عن أهمية علم النفس وسماته في هذا المقام صحيحاً فيما لو كانت المسألة التي نعالجها تتعلق بأحد موضوعات هذا العلم أو بفرع من فروعه، خاصة وأن معظم كتب علم النفس المنشورة بلغتنا تتناول هذه القضايا في فصولها الأولى بصرف النظر عن مهمتها وعناوينها. وهذا ما خبره القراء في بلادنا، ولم يجدوا، في كثير من الحالات، مسوغاً منطقياً له. غير أن الأمر يختلف إلى حد كبير حين تكمن مهمة العمل في تتبع مراحل تطور علم النفس، وعرض أهم مدارسه و أشهر تياراته والتعريف بزعماء تلك المدارس والتيارات وأنصارها، وتحديد الموقع الفكري لكل منهم. ففي حالةٍ كهذه يبدو ضرورياً أن يقوم المؤلف، في البداية، بإبراز الخصائص العامة لهذا العلم، التي ينبغي مراعاتها والنظر إليه على أساسها.
إنَّ الفهم الخاطئ لخصائص علم النفس يعدّ واحداً من الأسباب التي تدعو إلى العودة إليها من أجل توضيحها، وتحفز على تحديد غايات هذا العلم ووسائله. فقد شهد هذا العلم، وما يزال يشهد، تبايناً في وجهات نظر العاملين فيه، مثلما عانى، ويعاني حتى الآن، من آراء بعض المفكرين والمثقفين القاصرة حيناً، والسلبية أحياناً. وهذا ما يميز "مناخ" علم النفس عن "مناخات" العلوم الأخرى: الطبيعية منها والاجتماعية، ولو بدرجات متفاوتة.
صحيح أن التباين في الآراء الذي يصل في بعض الأحايين إلى حدّ التناقض في مضمار علم النفس كان سبباً للمواقف السلبية والقاصرة خارجه، وأن ما كان قائماً وما هو موجود الآن على "خطوط التماس" أو بعيداً عنها قليلاً إن هو إلا صدى أو، على الأصح، ردّ فعل على ما يجري في داخله، ولكنه صحيح أيضاً أن يكون التأثير عكسياً. ذلك أن موقف الآخرين من علم النفس وخلافاتهم تؤثر، على نحو ما، على ممثلي هذا العلم عبر العديد من القنوات، وفي مختلف الأطوار والمراحل التي يمرون بها قبل نشاطهم العلمي وأثناءه.
ولعل تأثير الوسط الثقافي للباحث السيكولوجي لا يقتصر على مرحلة عطائه العلمي، ولا ينحصر ضمن حدود معرفية معينة، وإنما يتعدى ذلك ليشمل جميع سني حياته وكافة عناصر وعيه وأشكاله. وربما وضع البعض مسألة تأثير الثقافة الاجتماعية على العالم السيكولوجي في مرحلة نضجه الذهني والفكري على هامش الصفحة، ريبةً في صحتها أو، في أحسن الأحوال، محاولةً لإعمال الفكر فيها وتحليلها والتأكد من صدقها. وهذا ما لا نستغربه حينما نعرف أنَّ ما يمليه إجراء كهذا هو النظر إلى الموضوع المطروح بنظرة أحادية الجانب، أي من زاوية الأثر الذي يحدثه فكر العالم السيكولوجي ونظرته إلى مادة نشاطه وموضوعه في وسطه الاجتماعي، دون الاهتمام إلى الحدّ الكافي بالجانب الآخر المتمثل في دور ذلك الوسط بمختلف حلقاته ودوائره، وخاصة القريبة والضيقة منها، في هذا الفكر. فمن خلال هذا الدور تتحدد آراء الباحث وتتشكل مواقفه.
إنّ مرحلة النضج والعطاء عند الإنسان عامة، والباحث خاصة، ما هي إلا نتاج التفاعل والتواصل الاجتماعيين وثمرة من ثمار التربية بأوسع معاني هذه الكلمة عبر المراحل العمرية السابقة. ومهما حاول بعض العلماء تجاهل أو تجاوز كنه هذه العلاقة واتجاهها، فإن المعاينة الدقيقة تكشف عن وجود بصمات الوعي الاجتماعي على مجمل نشاطهم كمظهر من مظاهر الوعي الإنسانيّ. وهذا ما عبر عنه الفيلسوف البريطاني برترند راسل حين قال: "إن كل الحيوانات سلكت سلوكاً يتفق مع الفلسفة التي يعتنقها الشخص الملاحظ قبل أن يبدأ ملاحظاته. بل وأكثر من ذلك، فإنّ هذه الحيوانات قد أوضحت الخصائص القومية لصاحب الملاحظة. فالحيوانات التي قام الأمريكيون بإجراء الدراسات عليها تندفع في حالة من الهياج وبنشاط واستثارة واضحة غير عادية، وفي النهاية تصل إلى النتيجة المنشودة عن طريق الصدفة. أما الحيوانات التي قام الألمان بملاحظتها فتقف ساكنة وتفكّر، وفي النهاية تصل إلى الحلّ الذي يكون بعيداً عن شعورها الداخلي"،(منصور طلعت وآخرون، 1978، 101).
وما يهمنا من قول راسل، ونحن بصدد الحديث عن علم النفس وتاريخه، هو ضرورة العودة إلى الفلسفات التي كانت المنطلقات النظرية لعلماء النفس على اختلاف نزعاتهم، للوقوف على دورها الكبير في نشاطهم العلمي والنتائج التي توصلوا إليها. ومن غير هذا الإجراء، وما لم توضع النظرية في سياقها التاريخي –الفكري تظل في الكثير من جوانبها ومفاهيمها مجردة بصورة ما، ويتحول التأريخ لها إلى مجرد وصف أقرب للتصوير منه إلى العلم.
ومن المفيد أن نسوق مثالاً لا يقل أهمية من حيث قيمته التعبيرية وقدرته على إبراز العلاقة المذكورة عمّا قاله راسل. فقد كرس أصحاب "الأنتروبولوجيا السيكولوجية" أو "علم النفس الأنتروبولوجي" نشاطهم لخدمة النظرية العرقية النازية. فوجد الألماني آرنولد في كتابه "البنى السيكوفيزيائية عند الدجاج" أن سلوك الدجاج الذي ينتمي إلى المناطق الجنوبية من الكرة الأرضية يغلب عليه الخضوع السريع للدجاج الشمالي الذي يظهر على سلوكه الميل إلى التفوق وحب السيطرة والرغبة في إخضاع الأنواع الأخرى من الدجاج لسلطته. ويقول زميله ومواطنه ينيش بوجود خصائص عرقية موروثة عند الكائنات الحية تجعل من تفوّق بعضها على البعض الآخر أمراً حتمياً وطبيعياً.(منصور ف، 114-116).
إنّ هذه الأحكام لا تحتاج إلى تعليق. فهي، أياً كانت الزاوية التي يُنظر إليها من خلالها، تبرز بجلاء آثار المنطلقات النظرية للباحث السيكولوجي على تفسيره لمظاهر السلوك المختلفة.
كما تؤكد على ضرورة وضع الواقعة العلمية السيكولوجية، مهما كان حجمها وامتدادها، في مسارها الصحيح، ودراستها وفقاً لذلك.
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول إن من غير الممكن معرفة جوهر الظاهرة من غير تتبع مراحل تطورها، والوقوف على كمية ونوعية الصلات التي تربطها بغيرها من الظواهر القريبة منها والبعيدة عنها، والوصول، أخيراً، إلى القانون الذي ينظم حركتها. وهذا ينطبق على ظواهر الطبيعة، مثلما ينطبق على الظواهر الاجتماعية والإنسانية. ومن خلال هذا الفهم يكون التشديد على أهمية دراسة تاريخ علم النفس. فعندما يتم تناول مراحل تطور هذا العلم، وإبراز سمات كلّ مرحلة منها، وربط هذه السمات بعضها ببعض من جهة، وربطها بالشروط الثقافية لنشأتها وتبلورها من جهة ثانية، يصبح واقع هذا العلم وأهميته واتجاهه من الأمور الواضحة إلى حدّ يمكّن الدارس من معرفة ما لهذا العلم وما عليه، والتنبؤ بما يمكن وما ينبغي أن يكون حاله في المستقبل.
لقد نشأت وتطورت مدارس سيكولوجية عديدة. وتأتي مدرسة التحليل النفسي في طليعة هذه المدارس من حيث انتشارها وذيوعها. إذ تعدى أثر هذه المدرسة في فترة ما بين الحربين العالميتين خصوصاً ميدان علم النفس إلى ميادين أخرى كالأدب والتربية والفن.
إن لظهور هذه المدرسة أو تلك أسبابه الموضوعية المتعلقة أساساً بثقافة المجتمع(أو المجتمعات) التي عرفته. وهذا يعني ببساطة أن أياً من هذه المدارس هي الابنة الشرعية للمجتمع الذي ولدت فيه. وتبعاً لتوجهاته وتوجيهاته(المباشرة وغير المباشرة) ومستوى قبوله بها وتقبله لها تنمو وتتطور. وانطلاقاً من ذلك يمكن تفسير ظهور السلوكية وتعديل تعاليم مؤسسها ونشوء السلوكية الجديدة، وكذلك ضعف صدى حركة التحليل النفسي بعد الحرب العالمية الثانية... الخ.
وما قيل يؤلف –بالنسبة لنا- المبدأ العام الذي سوف نعتمد عليه في عرضنا التاريخي لعلم النفس في القرن العشرين. ويتجسد هذا المبدأ، مرةً أخرى وباختصارٍ، في وحدة الفكر الإنساني بما يحمله من تناقضات أولاً، ووحدة شخصية الإنسان ووعيه ثانياً، وأثر هذا الفكر في الشخصية والوعي ثالثاً.
لقد تحدثنا، حتى الآن، عن جانب واحد من المسألة المطروحة. أما الجانب الثاني فيحتوي على الصورة التي يحملها جمهور المثقفين والمتعلمين من غير المشتغلين في حقل علم النفس عن هذا العلم. ونبادر للقول بأن هذه الصورة ما زالت تتسم حتى الآن بالكثير من المغالطات والتشويهات، على الرغم ممّا كتب ونشر حول علم النفس.
إننا لا نجد كبير عناء في البرهان على وجود مثل هذه الصورة لدى الأغلبية الساحقة من الناس. فالحياة اليومية تزخر بالأمثلة والشواهد. وهي تقدمها لنا في كل حديث، وعبر أي حوار أو مقابلة نجريها مع الآخرين. ولكي لا يظل كلامنا نظرياً وتعسفياً فإننا نستعين بالنتائج التي انتهى إليها الدكتور مصطفى سويف.
قام الدكتور سويف بدراسةٍ مسحية على عينة تمثل مختلف قطاعات المجتمع المصري، وذلك من أجل معرفة نظرة الناس إلى علم النفس، من حيث موضوعه وأهميته على الصعيد العملي.
وقد كشفت الدراسة عن وجود أكثر من 1/5 أفراد العينة البالغ عددهم 500 شخصاً، يحمل تصوراً يضع علم النفس في صف واحد مع السّحر والشعوذة، وأن 3/5 المستجوبين قصروا موضوع علم النفس على جانب واحد فقط، هو الجانب الانفعالي. واعترف خمسهم بعدم وجود أي تصور لديه عن الموضوع. ولم يستطع تقديم إجابة قريبة من الواقع، حول مجال اهتمام علم النفس سوى عشرة أشخاص فقط.
وبيّنت الدراسة أيضاً أن 47% من العينة لا يعرفون أي عالم أو باحث يشتغل في حقل علم النفس، وأن 40% أوردوا اسم فرويد(ومعظمهم لم يذكر إلا اسمه). بينما صرح 53% من المجموعة بأنهم لا يعرفون شيئاً عن علم النفس، ولم يقرؤوا أو يطلعوا على أي شيء يتعلق به. واقتصرت مطالعة 18% من العيّنة على كتب ليست ذات صلة بتراث علم النفس، ككتاب "كيف تكسب الأصدقاء؟..."، ومطالعة 10% على بعض ما كتبه فرويد أو بعض ما كُتب عنه.(سويف، 1978، 3-20).
وتدلّل هذه المعطيات على أن علم النفس لم يتبوأ بَعْدُ مكانته الصحيحة لدى فئة المتعلمين والمثقفين في مجتمعنا، وأن معالمه وموضوعات اهتمامه غير معروفة إلى حدّ بعيدٍ من قبلهم.
وما دمنا نتكلم عن التصور العام حول علم النفس فمن الضروري أن لا ننسى ما يعكسه هذا التصور من فهم لدور الاختصاصي النفسي ومهماته. إننا لو رجعنا إلى العيّنة التي وزع على أفرادها الاستبيان وطرحنا عليهم سؤالاً عن طبيعة عمل الاختصاصي النفسي، لألفينا أن نسبة من الإجابات التي يمكن أن يدلي بها هؤلاء تعبر عن فهم ضيق أو مشوه لهذا العمل. فقد يتصور الكثير منهم أن المشتغل في علم النفس أشبه ما يكون بالساحر أو المنجم أو المشعوذ، وأن علم النفس يمدّ الإنسان بقدرة عجيبة على معرفة ما يجري في أذهان الآخرين وما يفكرون به، أو ما يرغبون بالتحدث عنه، أو معرفة أسرارهم لمجرد إجراء حوار قصير معهم. وفي أحسن الأحوال قد يرى بعضهم أن مهمة الاختصاصي النفسي تتمثل في تشخيص الأمراض النفسية وعلاجها. إن لكل واحدة من الحالتين المذكورتين بعداً ثقافياً تتأثر به وتقوم عليه في تقديم مثل هذه الإجابات. فالحالة الأولى تعكس –كما هو بيّن- فهم ممثليها لوظيفة علم النفس من زاوية أحد فروعه فقط، وهو الطب النفسي، دون غيره من الفروع الأخرى، أو من وجهة نظر التحليل النفسي دون غيره من الاتجاهات السيكولوجية. في حين ينطلق هؤلاء في الحالة الثانية من نظرتهم إلى الاختصاصي النفسي إلى أنه يتعامل مع موضوعات غير محسوسة. وهي بالتالي –حسب اعتقادهم- ذات طبيعة غريبة لا يُعرف مصدرها ولا تدرك نشأتها. وواضحٌ ما تحمله هذه النظرة في طياتها من رواسب الفكر القديم.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى وجود عوامل موضوعية وأخرى ذاتية تدفع بحالات كهذه إلى الوجود. فمن غير الإنصاف أن نُحمّل المتعلم وحتى المثقف مسؤولية ذلك كله، ونعفي الدوائر الثقافية والإعلامية والتربوية في المجتمع منها، إذا لم يكن هدفنا تجريد هذه الدوائر من صلاحياتها وإلغاء دورها أو تقزيمه بحكم قبلي.
إن ما ذكرناه حتى الآن يعتبر أحد الأسباب التي جعلت من هذا الفصل أمراً لازماً. ومن خلاله نعتقد بأننا أجبنا على الاعتراض الذي استهلينا به الحديث. ونوجز ما قلناه في هذا الشأن بعبارات أوضح. إن مهمة هذا الفصل تتجسد في تناول دور علم النفس وأهميته، ومع التأكيد على الروابط القائمة بين هذه المسألة ومسألة تكون الظواهر النفسية وتطورها والقوانين التي يخضع لها إبان ذلك، فإننا نعتبر أن دراسة الأولى منهما هي مهمة تاريخ علم النفس، بينما تشكل الثانية المهمة المركزية التي يجب على علم النفس العام أن يضطلع بها.
يتبع.......ز