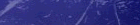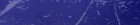الموضوع طوويل لاكنة مفيد لكل مدرس رياضيات ونتمنى ان يكون دا أهمية لكل مدرس أو طالب جامعي
يجلس في مقعده أمام سبورة تعج بالرموز والأرقام، وضجيج معلم يهتف بنظريات وقوانين وتعميمات، يحاول جاهداً أن يهيم في عالم الرياضيات، وأحلام اليقظة تصوره عبقرياً من عباقرة الرياضيات، يهز رأسه ليبعد عن نفسه شبهة عدم الفهم كلما التقت عيناه بعيني أستاذه، على الرغم من المحاولات الجادة لتلافي هذه النظرات، يختلس النظر إلى ساعته، عل عقارب الساعة تسرع ولو قليلاً، لتنتشله من مأزق الرياضيات، علامات متدنية، فهم مستعصٍ، جهود عابثة، "لماذا أتعلمها؟"، "ماذا سأستفيد منها؟"، "أمقتها!"....
وهناك على الطرف الأخر... معلم محبط، جهود جبارة، وذكاء محكم، ومنهاج يختم، لا يضيع دقيقة، معلومات وفيرة، متسلسلة ومتقنة، خبرة سنوات، ومع ذلك، لا نتائج ولا علامات، بل نفور واتهامات؟ ترى أين المشكلة؟
لن نحاول هنا إعطاء وصفة سحرية شافية لكل أمراض الرياضيات، وظواهر الإخفاقات والتعثرات، ولكن سنحاول أن ننظر للموضوع بعين التكامل والتواصل والشمولية.
ومضة تاريخية
لم تكن الرياضيات يوماً، شأنها شأن سائر العلوم، وليدة علم بحت، وبنى مجردة، أتت من الفراغ، إنما جاءت وليدة حاجة حياتية، ومتطلبات مادية، ثم تطورت رويداً رويداً، وتعمقت وتفرعت لتأتي بأشكالها المتنوعة، وفروعها العديدة.
فإذ نظرنا إلى جذور علم الرياضيات، في استعراض تاريخي سريع، نرى على سبيل المثال، أن علم المساحة والهندسة والحساب في مصر الفرعونية نشأ تحت ضغط الحاجات الاقتصادية والاجتماعية، ففيضانات وادي النيل دفعت المصريين القدماء إلى ابتكار طرق وأساليب هندسية لتحديد مساحات الحقول، وتنظيم الزراعة والري، كما أن اهتمامهم ببناء الأهرامات جعلهم يتقدمون في استعمال الخطوط والحساب... وتدل بعض الأبحاث الجديدة على أن الرياضيات كانت متقدمة عند البابليين، فلقد استعملوا الحساب والهندسة في دراسة حركات الكواكب والنجوم وقياس الزمن، وفي تنظيم الملاحة والفلاحة وشؤون الري....
من جهة أخرى، لا نستطيع أن نهمل طبيعة الرياضيات وبنيتها المجردة، ففي الوقت الذي لمسنا الضعف في الجانب المجرد في الرياضيات المصرية والبابلية، يمكننا القول أن اليونان أول من اتخذ الرياضيات علماً نظرياً مجرداً بحتاً، وقد اعتمدوا في معلوماتهم الرياضية الأولى على المصريين والبابليين.
كان موضوع الرياضيات عند اليونان ماهيات ذهنية كاملة تتمتع بوجود موضوعي مستقل عن الذات، غير أن تمسك اليونان بصفة الكمال في الكائنات الرياضية، جعلهم يقتصرون على دراسة الموضوعات التي يمكن إضفاء هذه الصفة عليها. لقد نقل اليونان الرياضيات من عالم الحس إلى عالم العقل، ومن التطبيق العملي إلى التفكير الميتافيزيقي.1
مما سبق، نرى أن الرياضيات عند اليونان، ومنهم أفلاطون مثلاً، كانت تنظر إلى الطبيعة على أنها تحقيق لنموذج متعالٍ هو الماهيات الرياضية، لكن تحليل الحركة أصبح يتطلب من الرياضيات الديكارتية تعريف اكتشاف علاقات هندسية تكون لغة الطبيعة، ولا تسكن سماء المعاني، كما كانت تقتضي منها اكتشاف علاقات هندسية بين عناصر الحركة، فلم تعد الطبيعة تكون وفق نموذج رياضي مسبق، بل أصبحت الرياضيات على العكس من ذلك هي التي تشيد وتبني حسب مقتضيات العلم الطبيعي الناشئ.
وهكذا، فقد كانت الحاجة ماسة في عصر ديكارت إلى أن تنزل الرياضيات من عالم التجريد الخالص مرة أخرى وتحرر المنهج العلمي من هيمنة الجدل المدرسي، وأن تواجه التعارض الذي أقامه مفهوم جديد عن طبيعة لا نفوس فيها ولا أرواح، تسودها حركة آلية مع مفهوم يستخدم العلة الغائبة والنماذج الحيوية لتفسير حركات الكون.
حاول ديكارت استخلاص التطبيقات العلمية من هذا العلم، تلك التطبيقات التي من شأنها أن تجعلنا سادة على الطبيعة وممتلكين لها. لقد كان ديكارت يحلم بتطبيق المنهج الرياضي على مجموع المعارف وتأسيس علم كلي منهجه واحد، وهو يرى أن ما يبرر وحدة العلوم هو وحدة العقل العارف، وفكرته عن وحدة العلوم تعكس وحدة المادة التي يتكون منها العالم، بحيث يكون الفلك والفيزياء، بل وحتى الطب، خاضعة للقوانين نفسها.2
كانت الرياضيات في البدء أداة لعلماء الطبيعيات، واستمر الحال حتى منتصف القرن الماضي، أما اليوم، فإننا نرى الرياضيات تغزو جميع فروع العلوم الطبيعية، وتلعب الرياضيات اليوم دوراً كبيراً في نظرية الاحتمالات، وفي العلوم الإلكترونية، والآلات الحاسبة، والاقتصاد بنظرياته يتحول تدريجياً إلى علوم رياضية، فالصناعة والتجارة تعتمد على اتخاذ القرارات، وهذه بدورها مرتبطة بالإحصاء والاحتمال ارتباطاً وثيقاً، كذلك الحال بالنسبة للطب والصيدلة والعلوم الاجتماعية والإنسانية.3
نظرة إلى واقع تعليم الرياضيات
الرياضيات هي دراسة أنظمة عامة تجريدية، وهذه الأنظمة تخدم دراسات خاصة أو مسائل تطبيقية متنوعة، وهناك العديد من النماذج الرياضية التي تناسب الواقع والحياة وتمثل أجزاءً منهما.
وفي نظرة إلى الواقع، نرى أن تعليم الرياضيات يواجه اتجاهات سلبية وعزوفاً وتدنياً في التحصيل وقصوراً في نقل المعرفة من سياق إلى آخر بشكل واضح وملفت للنظر. وقد تكون الأسباب عديدة ومختلفة، وليس الهدف هنا التحقيق في جميع الأسباب ومعالجتها، ولكن من بين الأسباب يكمن سبب مهم ومؤثر: ما لم يشعر المتعلم بحاجة واقعية لما يتعلم، وما لم تدرس المادة بشكل أصيل وفي سياقات واقعية، وما لم يستطع الطالب رؤية الرياضيات داخل النسيج العلمي الحياتي الكامل الذي يصنع رداء الحياة، ما لم ير الرياضيات شعراً أو قصة، أو مشكلة حياتية واقعية، ما لم ينمذج المسائل ضمن نماذج هادفة، ما لم ير تطبيق الرياضيات في الفيزياء والعلوم والتاريخ والكيمياء، ما لم يبنِ جسوراً وقناطر تصله من جزيرة إلى أخرى، بسلاسة وعفوية... لن تكون هناك رياضيات مفيدة، سهلة، ذات قيمة، وذات معنى... إلا لتلك الفئة الموهوبة التي تعشق الرياضيات كرياضة للذهن، وتشغف حل الطلاسم والرموز والمعادلات والأنماط، وتتذوق المعالجات الرياضية والنظريات والتعميمات والقوانين كلعبة للفكر وتنشيط للذهن، وهذه الفئة ما هي إلا قلة قليلة من جمهور المتفرجين الصاخبين.
إن الحياة بطبيعتها متشابكة، ومعقدة، ومتداخلة، وإذا كان التعليم جزءاً من طبيعة هذه الحياة، فلا بد أن يكون التعليم أيضاً متشابكاً ومتصلاً، فالدماغ ليس حجرات للرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، واللغة...، بل هو مساحة شاسعة فيها خطوط وتعرجات تخط بقلم التعليم لترسم لوحة ذات معنى.
ولنكن أكثر وضوحاً، دعونا نمعن النظر في الطفل الذي يتعلم صياغة الذهب، أو العمل في الألمنيوم، أو التبليط، أو البيع والشراء، أو الصرافة، أو النجارة،... وما إلى ذلك، مثل هذا الطفل يتعرض إلى رياضيات كثيرة دون أن يدري، وهو يتجاوب معها ويستوعبها ويتعامل بها، ويتجرع معها جرعات من الحياة ومهارات اجتماعية، ومعارف علمية أخرى، كل ذلك بصورة تلقائية وسلسة. ولو أن ما تعلمه من معارف قد صيغت في دروس كيمياء، ورياضيات، وفيزياء... وغير ذلك، لما اكتسبها ذلك الطفل. ما أقصد أن أقوله هو أن النقل من السياقات الحياتية إلى الصف والمدرسة، أسهل بكثير من نقل ما نتعلمه في المدرسة بصورة جامدة ومبرمجة إلى الحياة.
رؤية في تعليم الرياضيات
في إطار تواصلية المعرفة وتكاملها
في إطار تواصلية المعرفة وتكاملها
مشهد وقضية
يجلس في مقعده أمام سبورة تعج بالرموز والأرقام، وضجيج معلم يهتف بنظريات وقوانين وتعميمات، يحاول جاهداً أن يهيم في عالم الرياضيات، وأحلام اليقظة تصوره عبقرياً من عباقرة الرياضيات، يهز رأسه ليبعد عن نفسه شبهة عدم الفهم كلما التقت عيناه بعيني أستاذه، على الرغم من المحاولات الجادة لتلافي هذه النظرات، يختلس النظر إلى ساعته، عل عقارب الساعة تسرع ولو قليلاً، لتنتشله من مأزق الرياضيات، علامات متدنية، فهم مستعصٍ، جهود عابثة، "لماذا أتعلمها؟"، "ماذا سأستفيد منها؟"، "أمقتها!"....
وهناك على الطرف الأخر... معلم محبط، جهود جبارة، وذكاء محكم، ومنهاج يختم، لا يضيع دقيقة، معلومات وفيرة، متسلسلة ومتقنة، خبرة سنوات، ومع ذلك، لا نتائج ولا علامات، بل نفور واتهامات؟ ترى أين المشكلة؟
لن نحاول هنا إعطاء وصفة سحرية شافية لكل أمراض الرياضيات، وظواهر الإخفاقات والتعثرات، ولكن سنحاول أن ننظر للموضوع بعين التكامل والتواصل والشمولية.
ومضة تاريخية
لم تكن الرياضيات يوماً، شأنها شأن سائر العلوم، وليدة علم بحت، وبنى مجردة، أتت من الفراغ، إنما جاءت وليدة حاجة حياتية، ومتطلبات مادية، ثم تطورت رويداً رويداً، وتعمقت وتفرعت لتأتي بأشكالها المتنوعة، وفروعها العديدة.
فإذ نظرنا إلى جذور علم الرياضيات، في استعراض تاريخي سريع، نرى على سبيل المثال، أن علم المساحة والهندسة والحساب في مصر الفرعونية نشأ تحت ضغط الحاجات الاقتصادية والاجتماعية، ففيضانات وادي النيل دفعت المصريين القدماء إلى ابتكار طرق وأساليب هندسية لتحديد مساحات الحقول، وتنظيم الزراعة والري، كما أن اهتمامهم ببناء الأهرامات جعلهم يتقدمون في استعمال الخطوط والحساب... وتدل بعض الأبحاث الجديدة على أن الرياضيات كانت متقدمة عند البابليين، فلقد استعملوا الحساب والهندسة في دراسة حركات الكواكب والنجوم وقياس الزمن، وفي تنظيم الملاحة والفلاحة وشؤون الري....
من جهة أخرى، لا نستطيع أن نهمل طبيعة الرياضيات وبنيتها المجردة، ففي الوقت الذي لمسنا الضعف في الجانب المجرد في الرياضيات المصرية والبابلية، يمكننا القول أن اليونان أول من اتخذ الرياضيات علماً نظرياً مجرداً بحتاً، وقد اعتمدوا في معلوماتهم الرياضية الأولى على المصريين والبابليين.
كان موضوع الرياضيات عند اليونان ماهيات ذهنية كاملة تتمتع بوجود موضوعي مستقل عن الذات، غير أن تمسك اليونان بصفة الكمال في الكائنات الرياضية، جعلهم يقتصرون على دراسة الموضوعات التي يمكن إضفاء هذه الصفة عليها. لقد نقل اليونان الرياضيات من عالم الحس إلى عالم العقل، ومن التطبيق العملي إلى التفكير الميتافيزيقي.1
مما سبق، نرى أن الرياضيات عند اليونان، ومنهم أفلاطون مثلاً، كانت تنظر إلى الطبيعة على أنها تحقيق لنموذج متعالٍ هو الماهيات الرياضية، لكن تحليل الحركة أصبح يتطلب من الرياضيات الديكارتية تعريف اكتشاف علاقات هندسية تكون لغة الطبيعة، ولا تسكن سماء المعاني، كما كانت تقتضي منها اكتشاف علاقات هندسية بين عناصر الحركة، فلم تعد الطبيعة تكون وفق نموذج رياضي مسبق، بل أصبحت الرياضيات على العكس من ذلك هي التي تشيد وتبني حسب مقتضيات العلم الطبيعي الناشئ.
وهكذا، فقد كانت الحاجة ماسة في عصر ديكارت إلى أن تنزل الرياضيات من عالم التجريد الخالص مرة أخرى وتحرر المنهج العلمي من هيمنة الجدل المدرسي، وأن تواجه التعارض الذي أقامه مفهوم جديد عن طبيعة لا نفوس فيها ولا أرواح، تسودها حركة آلية مع مفهوم يستخدم العلة الغائبة والنماذج الحيوية لتفسير حركات الكون.
حاول ديكارت استخلاص التطبيقات العلمية من هذا العلم، تلك التطبيقات التي من شأنها أن تجعلنا سادة على الطبيعة وممتلكين لها. لقد كان ديكارت يحلم بتطبيق المنهج الرياضي على مجموع المعارف وتأسيس علم كلي منهجه واحد، وهو يرى أن ما يبرر وحدة العلوم هو وحدة العقل العارف، وفكرته عن وحدة العلوم تعكس وحدة المادة التي يتكون منها العالم، بحيث يكون الفلك والفيزياء، بل وحتى الطب، خاضعة للقوانين نفسها.2
كانت الرياضيات في البدء أداة لعلماء الطبيعيات، واستمر الحال حتى منتصف القرن الماضي، أما اليوم، فإننا نرى الرياضيات تغزو جميع فروع العلوم الطبيعية، وتلعب الرياضيات اليوم دوراً كبيراً في نظرية الاحتمالات، وفي العلوم الإلكترونية، والآلات الحاسبة، والاقتصاد بنظرياته يتحول تدريجياً إلى علوم رياضية، فالصناعة والتجارة تعتمد على اتخاذ القرارات، وهذه بدورها مرتبطة بالإحصاء والاحتمال ارتباطاً وثيقاً، كذلك الحال بالنسبة للطب والصيدلة والعلوم الاجتماعية والإنسانية.3
نظرة إلى واقع تعليم الرياضيات
الرياضيات هي دراسة أنظمة عامة تجريدية، وهذه الأنظمة تخدم دراسات خاصة أو مسائل تطبيقية متنوعة، وهناك العديد من النماذج الرياضية التي تناسب الواقع والحياة وتمثل أجزاءً منهما.
وفي نظرة إلى الواقع، نرى أن تعليم الرياضيات يواجه اتجاهات سلبية وعزوفاً وتدنياً في التحصيل وقصوراً في نقل المعرفة من سياق إلى آخر بشكل واضح وملفت للنظر. وقد تكون الأسباب عديدة ومختلفة، وليس الهدف هنا التحقيق في جميع الأسباب ومعالجتها، ولكن من بين الأسباب يكمن سبب مهم ومؤثر: ما لم يشعر المتعلم بحاجة واقعية لما يتعلم، وما لم تدرس المادة بشكل أصيل وفي سياقات واقعية، وما لم يستطع الطالب رؤية الرياضيات داخل النسيج العلمي الحياتي الكامل الذي يصنع رداء الحياة، ما لم ير الرياضيات شعراً أو قصة، أو مشكلة حياتية واقعية، ما لم ينمذج المسائل ضمن نماذج هادفة، ما لم ير تطبيق الرياضيات في الفيزياء والعلوم والتاريخ والكيمياء، ما لم يبنِ جسوراً وقناطر تصله من جزيرة إلى أخرى، بسلاسة وعفوية... لن تكون هناك رياضيات مفيدة، سهلة، ذات قيمة، وذات معنى... إلا لتلك الفئة الموهوبة التي تعشق الرياضيات كرياضة للذهن، وتشغف حل الطلاسم والرموز والمعادلات والأنماط، وتتذوق المعالجات الرياضية والنظريات والتعميمات والقوانين كلعبة للفكر وتنشيط للذهن، وهذه الفئة ما هي إلا قلة قليلة من جمهور المتفرجين الصاخبين.
إن الحياة بطبيعتها متشابكة، ومعقدة، ومتداخلة، وإذا كان التعليم جزءاً من طبيعة هذه الحياة، فلا بد أن يكون التعليم أيضاً متشابكاً ومتصلاً، فالدماغ ليس حجرات للرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، واللغة...، بل هو مساحة شاسعة فيها خطوط وتعرجات تخط بقلم التعليم لترسم لوحة ذات معنى.
ولنكن أكثر وضوحاً، دعونا نمعن النظر في الطفل الذي يتعلم صياغة الذهب، أو العمل في الألمنيوم، أو التبليط، أو البيع والشراء، أو الصرافة، أو النجارة،... وما إلى ذلك، مثل هذا الطفل يتعرض إلى رياضيات كثيرة دون أن يدري، وهو يتجاوب معها ويستوعبها ويتعامل بها، ويتجرع معها جرعات من الحياة ومهارات اجتماعية، ومعارف علمية أخرى، كل ذلك بصورة تلقائية وسلسة. ولو أن ما تعلمه من معارف قد صيغت في دروس كيمياء، ورياضيات، وفيزياء... وغير ذلك، لما اكتسبها ذلك الطفل. ما أقصد أن أقوله هو أن النقل من السياقات الحياتية إلى الصف والمدرسة، أسهل بكثير من نقل ما نتعلمه في المدرسة بصورة جامدة ومبرمجة إلى الحياة.